ياسر الأطرش لـ «عكاظ»: معركة «نزار» لا يدخلها عارف ! أخبار السعودية
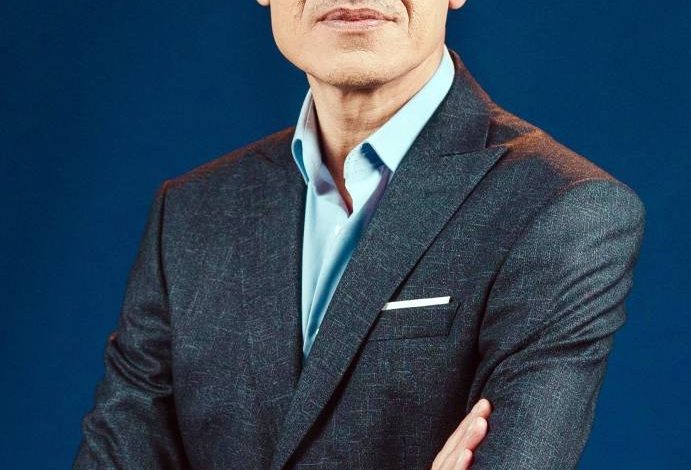
في برنامجه الشهير (ضمائر متصلة) يقدم الأطرش الصحافة الثقافية على أصولها من أجل (التوازن) الذي يضمن لنا الحياة، كما قال!
في هذا الحوار، وقفنا على آراء الأطرش في الجوائز الأدبية، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومشاهيرها الذين يراهم أصدقاء الحياة، وآرائه في المتخصصين الذين ينتجون لنا الزّيف، وأخذنا رأيه في معركة (نزار قباني) التي ما زالت رحاها دائرة في شبكات التواصل الاجتماعي.. فإلى الحوار:
• دعنا نبدأ من علاقتك الحرة بالقراءة والكتابة، كيف بدأت؟
•• منذ الصغر، بدأ اهتمامي بالشعر والقراءة في سن الثالثة عشرة، قبل ذلك كان اهتمامي بالشعر حفظاً وإلقاءً واضحاً لمن حولي، القصة بدأت من العائلة، كان أخي الأكبر الذي كان يدرس في كلية الشريعة بدمشق مولعاً باللغة، ونقل إلينا هذا الولع، حتى أنهيت في الصف السادس الابتدائي المعلقات العشر وحفظت كثيراً منها.
استمر عشقي للغة والشعر، وبدأت منذ الصف السابع تكوين مكتبتي الشخصية الخاصة، ولم ألبث طويلاً حتى كتبتُ الشعر في سن السادسة عشرة، وقررتُ بكل إصرار: أنا شاعر.. وحسب.
تنوعت القراءات ومصادر المعرفة بعد ذلك وفق التوجهات الفكرية، قرأت للشيوعيين والإسلاميين والتنويريين.. قرأت أدب القدماء والمحدثين، وكان الأصدقاء يستغربون من مكتبتي التي تضم النقائض، كلُّ عمل معرفي إنساني يهمني وأحترمه، أختلف معه وقد أكتب في نقضه، ولكنني أحترمه.. ومن هنا بنيتُ شخصيتي المستقلة فكرياً وثقافياً وسياسياً، والمؤسسة هوياتياً بشكل واضح لا تداخل فيه ولا سديم.
• ماذا عن المنفى في واقع ياسر الأطرش؟
•• قديم جداً، منفاي كان وما زال في داخلي.. غريباً كنتُ في أهلي ومجتمعي وبلدي، إنها غربة المثالي الذي يقاتل طواحين الهواء، يريد الأنقى والأصلح، وهذا هو المستحيل الاجتماعي.. وعلى غربتي تلك؛ كنت ابن أهلي البار، وابن مجتمعي، لم أتعالَ ولم أعتزل ولم أخاطب الناس من علٍ، حتى بعد نضج تجربتي ونيلي قسطاً من الشهرة.. ولعلَّ في البيتين الآتيين حلاً لهذه المعادلة:
أنا ابن أبي، أفنى ثمانينَ حجةً وما زال وضَّاءً تقيَّ الملامحِ
أنا ابن أنا، لا شيء يسبق همتي وإني غريبٌ في ثمودٍ كصالحِ
فأنا ابن أهلي، وفاءً… وأنا ابن منفاي، انتماءً
ويكبر المنفى في أوقات عجز الأسئلة الكونية، يكبر حتى لكأنه يضيق بنا حدَّ الاختناق..
هنا يتجاوز النفي المعنى السياسي أو الاجتماعي، هنا نُنفى من الوجود ونعوم في اللامكان واللامستقر، وهنا يجود ضميري بأبهى ما يمكن أن أجترح من بوح، في لحظات عجزي تلك، أتهجد وأناجي:
يا ربّ وقتاً أستريح.. لقد تعبتُ
يا ربّ لا أمٌّ ألوذ بحضنها
فمن الذي يحنو عليَّ إذا بكيتُ؟
يا ربّ يوجعني الحنينُ
وأنني لا أشربُ المكدورَ من ماء الحياةِ وإن هلكتُ
يا ربّ ضاع الحقّ بين غشاوتينِ
وإنني لن أعبد الأصنامَ بعد إذ اهتديتُ
يا ربّ بيتاً أنتَ تعلمهُ
فما في الأرض بيتُ…
• بعد اثني عشر ديواناً شعرياً، ما الذي بقي من الشعر لم تكتبه؟
•• لن أستعير هنا قول ناظم حكمت، كعادة الشعراء في هذا المقام، لأقول: أجمل الشعر ما لم أكتبه بعد!
كتبتُ كثيراً مما أريد، ترجمتُ كثيراً من هواجس نفسي وخلجات روحي إلى قصائد أحبها.. سأكتب اللحظات الجديدة التي تأتي، سأكتب الحاضر والمستقبل، سأكتب اللحظات الجديدة التي سأعيشها، لن أكرر نفسي من أجل أن «أبقى تحت الضوء» فقط، هذا مقتل كثير من المبدعين الكبار، البقاء تحت الضوء.. للأضواء سبل كثيرة، أن تكون فراشة مثلاً.. أن تشتغل على مهارات أخرى، أن تطور تجربتك الشعرية وتتجرأ على ما كنت تخشاه.. المهم؛ بقي أن أكتبَ ما يأتي، بلغته وطريقته وأدواته ومشاعره.
• الجوائز الأدبية ينتقدها كثير من الأدباء والمثقفين ويقللون من شأنها، لكنهم يسعون إليها، لماذا؟
•• الذين يفعلون ذلك لا يحترمون أنفسهم، الموقف من الجوائز سهل ولا يحتاج مداورة.. معها أو ضدها أو بين ذلك مفنداً كل حالة على حدة.. أؤكد رأيي بأن الشاعر أو الأديب عامة يذهب إلى الجوائز لغايتين: المال أو المعنى (التقدير، المكانة، الشهرة…) وهذا حقه، أما مدح التي ننالها وذم التي تمتنع عنا، فتلك صبيانية ممجوجة ومعيبة.
وجوائز الأدب ضرورة شأنها شأن مثيلاتها في الفن والرياضة وغير ذلك.. يستحق الأدب التكريم، ويستحق الأدباء الجوائز المادية والمعنوية، ولكن للجوائز درجات ومراحل أرى أن الأديب النبيل يقدِّرها ويحترمها، فلا ينافس الأستاذ الشباب الجدد، ولا يكتب الأديب تحت الطلب ضد قناعاته لوجه جائزة.. وعند حدّ معين يكتفي الكبير بالاحتفاء والتكريم.
• «الصحافة الثقافية» هل بقي لوجودها لزوم؟
•• طالما هناك من يقرأ، فلتبقَ.. العمل الثقافي الجاد لم يكن يوماً في المتن، إنه دائماً عمل هامشي، وهذا لا يقلل منه، فالباطل متنٌ والحقيقة هامش.. أضحك من كل قلبي عندما أرى بعض أصدقائنا المثقفين يطلبون معاملة الأديب مثل الممثل أو نجم كرة القدم! إنه طلب ضد المنطق الاجتماعي، هؤلاء وأضرابهم نجوم المجتمع مذ وُجد المجتمع، من الذي يصدق أن الفلاسفة أو العلماء أو الشعراء كانوا نجوم مجتمعاتهم يوماً؟! أبداً لم يكونوا، دائماً كان الناس يصنعون أبطالهم الأقرب إليهم، والأقرب يعني الأبسط والأكثر قدرة على تقديم سلعة (الإمتاع)، لذا سيظل مطرب شعبي من الدرجة الخامسة أشهر بكثير من عبدالرزاق قرنة! وهذا هو الطبيعي، لكن يجب أن نحافظ على الهامش الذي ننشط فيه وتنشط فيه الصحافة الثقافية التي تعرِّف بعبدالرزاق قرنة.. إنها مهمة عظيمة، إننا بذلك نضمن توازن الحياة، بالأحرى: نصنع هذا التوازن.
• الأدباء، هل ضيّقوا مساحة الثقافة؟
•• نعم، لا شك، عجيب وغريب حصر الثقافة في الأدب، حتى صار مفهوم الثقافة عند الناس يعني: الشعر، القصة، الرواية.. حتى السينما والمسرح والرسم خارج هذا التوصيف الخانق. الثقافة هي كل الحياة، كل المعرفة، والمعرفة هي كل الإنسان.
• هناك من حاكم البيت والقصيدة القديمتين محاكمة ثقافية، كما فعل علي الوردي من قبل في النقد الاجتماعي، وعبدالله الغذامي في النقد الثقافي، وكما فعل الشاعر والأكاديمي أحمد التيهاني مع معلّقة عمرو بن كلثوم أخيراً، كيف تنظر كشاعر لمثل هذه المحاكمات التي قد تكون أنت واحد من ضحاياها بعد سنوات طويلة؟
•• النقد الأكاديمي هو الأصل، على أنه غير كافٍ وحده، النقد الثقافي ضرورة، ويمكن له أن يشمل الاجتماعي كذلك، فدراسة السياقات لا تنفصل عن دراسة النص، إلا أن ذلك علم أيضاً، وما أنتجه الدكتور الغذامي في هذا الباب جدير بالدرس والتعلم منه، وهو لا يوضع في كفة ميزان مقابل ما يصدر عن غير علم ولا هدىً في بعض البرامج التي صارت تستجدي المشاهدات واللايكات في زمن الفوضى هذا.. دراسة السياقات الثقافية والاجتماعية بالتأكيد هي ضد نزع الشاعر من تاريخه وسياقاته، ما يحدث في محاكمة الشخصيات التاريخية والتراث مؤلم، ولكنه بالنسبة لي مضحك أيضاً، لا أتابع أبداً أي شيء من هذا، ماذا سأتابع في حديث شخص يحاكم قائداً عسكرياً مر على وفاته ألف عام بمصطلح عمره أقل من مئة عام؟! أو في مؤرخ يقارن بين قبيلة عربية والناتو! هذا الخطاب الشعبوي هو سرطان المرحلة، علينا أن نواجهه بخطاب ثقافي معرفي أخلاقي محترم، وكفى.
• لماذا تلبّستك شخصية أبي العلاء المعرّي؟
•• إنه جدي، أنا من معرة النعمان، غادرها جدي لأبي إلى سراقب (25 كم عن المعرة) ووُلد فيها أبي، ونحن.. تعرفتُ إلى شعر المعري صبياً، فتنني الشيخ الذي رأى كل ما عمينا عنه.. كبرياؤه وهمته: أتم تحصيل العلم في العشرين وجلس أستاذاً بعدها، زهده وغناه عن الناس، علمه الغزيز: كان شاعراً عظيماً، فيلسوفاً فذاً جريئاً، عالم فلك، راوية حديث، وواحداً من أعلم الناس بالعربية وفنونها، حريته الفكرية والعقائدية، غموضه في حياته وبعد موته، هوان الحياة عليه..
كتبتُ فيه كثيراً، ومن ذلك عتابي له أنه لم يكن أبانا:
«جنيتَ فلم تكن يوماً أبانا
ولم تمدد يديك، فتاهَ جيلُ
أتتركنا بلا أفقٍ وتمضي
وخلف عماك تختبئ الحلولُ»
• شبكات التواصل الاجتماعي، هل كسرت الاغتراب وألغت فاعليّة أدب المهجر؟
•• السؤال ينطلق من علاقة أكيدة بين الجغرافيا والاغتراب.. وهذا، وفق ما أرى، متغير من زمن إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، حتى أجدادنا كانوا يرون في الاغتراب والترحال ضرورة حياتية وسبيلاً إلى العلم والمال وربما تحصيل وسط اجتماعي أفضل! الأمر اختلف مع نشوء الدول الوطنية، هذا في المعنى الثقافي العام وليس الفردي، وما يعضد وجهة النظر تلك أن مصطلح أدب المهجر ظهر فعلاً مع نشوء الدول الوطنية أو الأحزاب والأفكار الداعية لها في المنطقة العربية..
أما عن وسائل التواصل فقد زادت الاغتراب وعمقته، حتى جعلت أفراد الأسرة الواحدة غرباء عن بعضهم بعضا، وسائل التواصل جعلتنا نعيش وحيدين تماماً وسط عالم مزدحم جداً، مزدحمٍ بظلال ملايين الناس، ليس إلا..
• لماذا يهاجم الأدباء والمثقفون مشاهير التواصل الاجتماعي، هل هي الغيرة أم الحسد؟
•• بالنسبة لي: لا هذا ولا ذاك، (المشاهير والمؤثرون) الإيجابيون أو حتى العاديون، الذين يشتغلون على محتوى مميز أو عادي، هم أصدقاء الحياة.. أما أولئك الذين يدمرون الإنسانية ويجرون الحياة من شعرها إلى مذبحها، بإنتاج كمٍّ هائل من التفاهة والتجهيل والبشاعة، فهم أعداء المعرفة، أعداء الحقيقة، إنهم جنود العدم الذين يهددون جوهر الإنسان بالإعدام.
• أما زلت مؤمناً بأنّ «الأمّة التي ليس لديها شعراء تموت من البرد»؟
•• جداً، هذا إيمان راسخ لا يتغير، البشرية تنتج كل شيء للجسد، إنتاج واستهلاك بلا حدود، ولكن الروح عارية منكشفة، وإن لم نتداركها بكثير من الجمال، ستتجمد وتموت من البرد.
• كتابك (أكاذيب نحبها) كشف أنّ الباحثين لدينا، وكثيراً من الدارسين لم يكونوا جادين في التدقيق أثناء البحث بما يكفي، هل تتفق؟
•• أنا منذهل مما يجري في عالم التحقيق، هل يُعقل أن يروج بين السواد الأعظم من الناس، وعدد غير قليل من الأدباء والمثقفين، أن هراء (صوت صفير البلبلِ) هي قصيدة للأصمعي؟ و«هي وهي هي ثم هي وهي هي» قصيدة لامرؤ القيس؟ يا للكارثة!
الكارثة الأكبر أن متخصصين ينتجون هذا الزيف، فإذا عدنا إلى قصيدة (يموت ببطء) الشهيرة عالمياً، سنجد أن من ينسبها إلى بابلو نيرودا هم شعراء الحداثة العرب، بل منظّروهم ومشهوروهم، ومرة أخرى يا للكارثة!
عندما بدأت المشروع، كنت أرصد بعض قصص القصائد، وشيئاً فشيئاً بدأت أكتشف الزيف في نسب القصائد الشهيرة، فبدأت الاشتغال عليها بهمة ومنهجية وجهد، لا أصدق الصحف أو النقلة، أذهب إلى المصادر نفسها، أقاطع المعلومة في أكثر من كتاب وتحقيق، حتى أخلص إلى الحقيقة أو ما يقاربها.
وبدأت أتساءل: أين جهد الأكاديميين ومراكز البحث في هذا الباب؟ إنه شبه معدوم، لذا قررت مواصلة المشروع، وسيصدر جزء ثانٍ من (أكاذيب نحبها) هذا العام أو العام القابل، وبعده، إن شاء الله، جزء ثالث ورابع.. يقول قائل: ما أهمية أن تكون رائعة (والله ما طلعت شمس ولا غربت) للحلاج أو لسواه؟ أقول ربما كان الأمر غير مهم للمتلقي والقارئ أو المستمتع بها أغنية لطيفة، ولكنه مهم جداً للباحث والمؤرخ والمتخصص، مهم للحقيقة، ومهم أكثر للعقل، مهمٌ جداً أن نحترم عقول الناس وأن نصرَّ عليهم أن يحترموا العقل، فعقلٌ يتغنى بصوت صفير البلبلِ على أنها إعجازٌ لغوي، هو في كارثة حقة! والمسؤول هو الدارس أو الباحث المتخصص الذي تقاعد من وظيفة الحقيقة.
• انشغل المبدعون في السنوات الماضية بإرضاء النقاد، وانشغلوا اليوم بإرضاء الناس.. عامة الناس، من وجهة نظرك مبدعاً وناقداً ومن الناس بمن المفروض أن ينشغل المبدع؟
•• التنظير في هذا الأمر سهل، ولكن الحقيقة مرة، أقول لك بصراحة وجرأة: كثير منا يكذبون في الإجابة عن هذا السؤال، من فورنا نقول لك: لا لا، أنا لا أحسب إلا حساب القصيدة.. هذا ليس صحيحاً إلا عند ندرة من الشعراء المتمردين غير المنشغلين فعلاً بالجماهيرية والجوائز والأضواء.. أعرف شعراء يكتبون للنقاد في الجوائز والمسابقات، ويكتبون للجمهور في المناسبات، وأقول أكثر من ذلك: اشتغل الشعراء العرب طيلة العقود الماضية في مهنة (حكّ الجرب).. نعم حكّ الجرب.. أعني مسايرة شعارات المراحل سياسياً واجتماعياً، ننتكس: نشتم الحكام العرب، يصفق لنا الجمهور.. ننتصر، وإن انتصاراً وهمياً: نتفاخر ويصفق لنا الجمهور المنتشي بالنصر.. شعراء للطوائف والمذاهب، شعراء لشتم التاريخ والتراث، وآخرون لشتم الحداثة.. ولكل شاعر حساباته التي هي في مجملها (شعبوية) تحاكي حاجات السوق..
إذن لمن ينحاز الشاعر؟.. ينحاز للإبداع، الجمال، الإنسانية، الحقيقة، المحبة
سنحبُّ ما دمنا نعيش
ونعيش ما دمنا نحبُّ
ملاحظة: أنا وقعتُ في بعض ما ذكرته عن (حك جرب الجمهور)، ثم نضجت وتبت.
• هل تجاوزت ثقافتنا اليوم صراع القديم والجديد، والتفتت إلى الحالة الإبداعية بشكل أكبر من الشكل الكتابي؟
•• قليلاً، الوضع أهون من زمن المعارك الأدبية (من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين) ولكنه أقل نضجاً أيضاً، معركة التراث والحداثة لن تنتهي، ولا أرى فيها من بأس، على أن تكون معرفية واعية ناضجة هدفها البناء لا الهدم، وهذا هو الشرط غير المتحقق، إذ تطغى (الشعبوية) على خطاب وحوار اليوم، كارثتنا الكبرى الشعبوية، وتصدي أي أحد لأي موضوع، الكل يتكلم في غير فنه ويأتي بالعجائب! والمنصات تنتج والجمهور يستهلك بلا شروط ولا قوانين ولا حدود.. الحداثة حالة فكرية وليست مظهراً أو ادّعاءً، والقدامة أصالة يجب أن تستهدف ولوج المستقبل بقوةٍ وتحدٍ وأدوات قابلة للتفوق.
الإقصاء حالة غبية، لا أعرف لماذا نجرب ما فشل فيه غيرنا لقرون؟!
ولا أفهم لماذا نصر على أن في العالم لونين فقط: أبيض وأسود! ولماذا يجب أن أكون المصيب دائماً؟ لماذا ما زلنا نسشتعر لذة في تخطيءِ الآخر؟ أليس من الأفضل والأجدى أن يكون في حياتنا كثير من الأذكياء والجيدين والمبدعين؟
أنا أحب الجواهري وأحب رياض الصالح الحسين، أحب المتنبي والمعري وبدوي الجبل وأحب أمل دنقل ودرويش والسياب ومحمد الثبيتي وعبداللطيف اللعبي.. أحب الشعر والجمال وفتنة اللغة ودهشة المعنى.
• ماذا تقول لمن يرى اليوم أنّ (نزار قباني) ليس شاعراً؟
•• هذه معركة لا يدخلها عارف، الأمر أقل بكثير من أن نعطيه أهمية..
أجاب نزار نفسه من زمان:
«اللاهثون على هوامش عمرنا سيّان إنْ حضروا وإن هم غابوا».

